هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أفكَار
العلمانية من عصر الأنوار إلى الظلامية.. الجزائر نموذجا

إذا كان المشرق العربي يؤرخ لبداياته الأولى في التعرف على العلمانية مع بداية القرن التاسع عشر على يد رفاعة الطهطاوي الذي أرسله محمد علي باشا إلى فرنسا مع البعثة الفرنسية للدراسة، ومن هناك كان كتابه "تلخيص الإبريز في تخليص باريس".. وقد كانت فرنسا وقتها مركزا للأنوار بروادها فولتير وجون جاك روسو وغيرهما أي مركزا للعلمانية، فإن بلدان المغرب العربي، وعلى رأسها الجزائر، كانت تحت حكم فرنسا نفسها، تصارع حالة من التناقض الغريب، بين الشعارات النورانية / العلمانية التي ترفعها فرنسا آنذاك، وحالة الاستبداد والاستيطان المتجذر الذي تميز به الاستعمار الفرنسي للجزائر أكثر من غيرها.
ولعل نشأة العلمانية في الجزائر في هذه الظروف غير الطبيعية، جعلت منها علمانية "متوحشة" ضمن جناح من الحركة الوطنية "الاندماجية" التي كانت مستعدة للتخلي عن القيم الإسلامية بشكل كامل بفعل قوة الاستلاب الفكري والعسكري الذي كان يمارسه المستعمر، وقد مثل هذا التيار فرحات عباس الذي صرخ صرخته المشهورة في 1936 "فرنسا هي أنا"، مستنكرا وجود أمة جزائرية بالأساس، تقابله حالة من التدين "الصلب" الذي انتهجه جناح آخر من تلك الحركة الوطنية (جمعية العلماء وحزب الشعب الجزائري) باعتبار الإسلام آخر حصون المقاومة لاستعمار لم يكتف باحتلال الأرض وإنما تعداه لمحاولة احتلال العقول أيضا.
وفي حدود نهاية القرن التاسع عشر، لعبت في الجزائر الانعكاسات المتناقضة هذه بين أطروحة الأنوار الفرنسية وادعاءاتها الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان، وبين الواقع الجزائري المتسم بالظلم والاستعباد الكولونيالي، دورا هاما في تقسيم النخب التي أنتجتها المدرسة الفرنسية نفسها حول طبيعة العلمانية المنتهجة، وذلك بشكل أكثر مما أحدثته في بلدان المشرق العربي أفكار علي عبد الرازق، طه حسين، وخالد محمد خالد وغيرهم، لذلك ارتبطت الفكرة العلمانية في الجزائر زمن الاستعمار بالفكرة "الاندماجية" أو التيار الإلحاقي المرتبط كلية بفرنسا وثقافة فرنسا مع معاداة فجة للإسلام والعروبة وهوية الشعب.
بينما تحولت هذه "الاندماجية" العلمانية بعد الاستقلال إلى ما يشبه الدعوة إلى الفرعونية التي تزعمها طه حسين في مصر، عبر الترويج للقطيعة مع كل ما أتى من شبه الجزيرة العربية (الإسلام)، حيث استبدل دعاة العلمانية في الجزائر الفرعونية "بالأمزغة" أو الدعوة للهوية الأمازيغية، وإلى القطيعة مع كل ما أتى من شبه الجزيرة العربية، أي الإسلام ومعها العربية.
خارطة العلمانية في الجزائر
تتوزع خارطة التيارات العلمانية في الجزائر بين الشيوعية والاشتراكية والليبرالية والوصولية المنتفعة، وهي تكاد تكون مختلفة في كل شيء تقريبا، إلا في نقطة واحدة وهي العداء السافر لما يسمونه "الأصولية الإسلامية"، فالعلمانية العربية وتحديدا في الجزائر، لا تعني المفهوم الأصلي لها وهو الفصل بين "السياسة والدين"، وإنما تعني "العداء للدين"، وليس أي دين بالطبع، وإنما العداء للدين الإسلامي تحديدا دون غيره، بدليل حجم التسامح الذي تتعامل به هذه العلمانية مع عمليات بناء الكنائس في بعض المناطق الجزائرية مثل منطقة القبائل، بل وحتى الموقف من اليهود حيث لا يمانع هذا التيار في مجمله عملية التطبيع، بعكس باقي شرائح المجتمع الجزائري.
ويبرز الشيوعيون هنا كقاطرة لهذا التيار، على الرغم من أن "الحزب الشيوعي الجزائري" الذي التحق متأخرا بالثورة، كان تاريخيا بمثابة الفرع الجزائري للحزب الشيوعي الفرنسي قبل ثورة التحرير، لذلك فهو لا يكاد يختلف عن نظيره الفرنسي من حيث العداء السافر للانتماء العربي الإسلامي للجزائر، وتبني القيم الفرنسية فكرا وسلوكا، وقد تسلل هؤلاء إلى مفاصل الدولة بعد الاستقلال خاصة في زمن بومدين، أين استغلوا التوجه الاشتراكي للدولة، ليقوموا بأكبر المجازر الثقافية في حق الشعب عبر دفعهم الدولة إلغاء معاهد التعليم الإسلامي بشكل نهائي عام 1975، وعرقلة كل المشاريع التعليمية ذات الطابع العربي والإسلامي، مع السيطرة على النقابات العمالية بما في ذلك الاتحاد العام للعمال الجزائريين الرسمية، وقد لعب حزب الطليعة الاشتراكية الشيوعي في سنوات الستينات والسبعينات دورا محوريا في تمكين العلمانيين من مفاصل الدولة، وقد برز في قياداته بعد التعددية السياسية عقب أحداث أكتوبر 1988 الأمين العام لحزب الحركة الإجتماعية الديمقراطية الهاشمي شريف، وكذلك المناضلة "التروتسكية" لويزة حنون زعيمة حزب العمال.
كما أن حزب جبهة القوى الاشتراكية (يدافع عن الهوية الأمازيغية) بقيادة المناضل حسين آيت أحمد، الذي رفع حزبه السلاح في وجه نظام بن بلة مباشرة بعد الاستقلال، بحجة الشمولية والديكتاتورية العام 1963، صدم الكثير من الجزائريين وحتى المتعاطفين معه، بعد المسيرة الحاشدة التي قام بها في العاصمة الجزائرية بداية يناير 1992 اعتراضا على فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بتشريعيات 26 ديسمبر 1991، وقد كانت تلك المسيرة التي رفعت فيها شعارات مثل "لا للدولة الأصولية" و"لا لإملاءات الإسلام"، غطاء شعبيا لجنرالات الجيش لكي يقوموا بالانقلاب على نتائج الصندوق الانتخابي، وإقالة الشاذلي بن جديد، ودخول البلاد في عشرية من الدماء والدموع.
ويبرز بين العلمانيين الليبراليين حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (هو أيضا يدافع عن الهوية الأمازيغية) الذي كان بقيادة زعيمه سعيد سعدي، وقد كان من أشد المعارضين لفوز جبهة الإنقاذ، بغض النظر عن الشعارات الديمقراطية التي يتغنى بها هذا الحزب، وقد سجل التاريخ بكثير من الدهشة تلك المناظرة في التلفزيون الجزائري الرسمي مع بداية الانفتاح السياسي بين زعيم الجبهة الإسلامية للإنقاذ الدكتور عباسي مدني رحمه الله، وزعيم هذا الحزب العلماني، عندما قال هذا الأخير بكل وضوح أمام ملايين المشاهدين موجها كلامه إلى الدكتور عباسي: "لن نترككم تصلون إلى الحكم"، وقد فعلوا.
كما تبرز أحزاب وشخصيات أخرى علمانية تركت بصمتها في الحياة السياسية الجزائرية مثل حزب "الحركة الشعبية الجزائرية" بقيادة عمارة بن يونس الحزب الذي انخرط في دعم الرئيس السابق بوتفليقة ولم يقدم شيئا للبلاد سوى قانون يتيح بيع الخمور دون ترخيص من المصالح التجارية، بالإضافة إلى أسماء يعرفها الجزائريون بعلمانيتهم الصارخة في الميدان السياسي من أمثال رضا مالك رحمه الله، خليدة تومي، بينما تمتلئ الساحة الثقافية والإعلامية بهذا التيار حد التخمة، والذين ليس لهم من برنامج واضح إلا ازدراء دين الأمة ولغتها، والدعوة إلى هوية أخرى، وحلول تأسيسية تعيد بناء الدولة على أسس معادية تماما لبيان أول نوفمبر التاريخي الذي استشهد من أجله مليون ونصف مليون من شهداء الجزائر.
علمانية متوحشة
ومن الطبيعي هنا أن تكون العلمانية الجزائرية، علمانية غير ناعمة بقدر ما هي "متوحشة"، بالنظر إلى رفضها الكامل الاعتراف بهوية الشعب وثوابته، واستعدادها أن ترمي القيم والشعارات "الديمقراطية" إلى المزبلة، إذا ما تعلق الأمر بمواجهة ما تسميه "الظلامية الإسلامية"، فكان تخندق هذا التيار بجميع فروعه تقريبا إلى جانب الانقلاب العسكري الذي مهدوا له ودعموه في العام 1992 ضد الإرادة الشعبية التي انتصرت للإسلاميين، سقوطا مدويا لكل الشعارات البراقة التي رفعها العلمانيون (ديمقراطيون وجمهوريون) من قبل، كالديمقراطية والحرية، وأن الديمقراطية التي يؤمنون بها هي فقط التي توصلهم إلى دفة الحكم وتمنع غيرهم، وأن الحرية التي ينادون بها هي فقط الحرية التي تبيح لهم الدوس على قيم الإسلام والدعوة إلى الشذوذ والمثلية.
لقد اتضح جليا أن العلمانية في الجزائر، ليست مشروعا سياسيا مختلفا، يقبل بمعركة الأفكار ويخوض غمارها في صناديق الانتخابات، بقدر ما هي جسم غريب موبوء، تحمل كل معاني الديكتاتورية والشمولية، بدليل أن أقطاب التيار لا يبرحون يعلنون رفضهم المطلق القبول بأن يكون الإسلام هو الموجه في البلاد، حتى وإن انتخب الشعب كله عليه، أما عداؤهم للغة العربية فهو لا ينفصل عن عدائهم للغة القرآن، وقد كان من أسباب دفعهم للانقلاب العسكري عام 1992 هو منع التوقيع على قانون تعميم استعمال اللغة العربية الذي أصدره الشاذلي بن جديد، لتبقى الفرنسية (لغة الأنوار الفكرية الباريسية هي المسيطرة).
ولو حاولنا أن نسرد دلائل "الوحشية" العلمانية في الجزائر، فلن تسعنا صفحات الكتب، فهم ضد بناء المساجد ومنه بناء المسجد الأعظم الذي تعرض لحملة تشويه شنيعة، وضد انتشار الدعوة الإسلامية، لكنهم في المقابل مع بناء الكنائس ومساندة المنصرين بدعوى حرية المعتقد، كما وقفوا وراء ظاهرة الانحلال الأخلاقي عبر الترويج الإعلامي للقيم المتفسخة، واعتبروا الشذوذ الجنسي حرية شخصية، وللأسف الشديد فإن العلمانيين في الجزائر، يجعلون من "النزعة البربرية" حصان طروادة في مواجهتهم للإسلاميين، فهم جميعا يرفعونها تقريبا كنزعة يستميلون بها البسطاء من البربر المعروفين بحبهم للإسلام للدخول في خصومة عقائدية مع دينهم ودين آبائهم، وقد نجح العلمانيون في المدة الأخيرة وإلى حد بعيد في تثبيت الخطة الفرنسية في السيطرة على المشهد عبر إحياء النعرات العرقية لتكون المواجهة الفكرية والحضارية بين فسطاطين مختلفين تماما، الإسلاميون العروبيون في مواجهة العلمانيين البربريست الفرونكوفيليين.
وهذه النقطة تحديدا التي كانت قاصمة الظهر والانقسامات والمآسي التي عرفها الحراك الشعبي في الجزائر الذي انطلق في 22 شباط (فبراير) 2019 ضد حكم بوتفليقة، حيث اتضح أن التيار العلماني عمد إلى رفع الرايات "الأمازيغية" بغرض التمايز عن جسم الحراك الوطني الإسلامي، قبل أن يقوم بالالتفاف على الشعب وتكرار انقلابه القديم على إرادة الشعب، بالتحالف مع منظومة الحكم لقاء مزايا ومصالح يدرك جيدا أنه لا يمكنه الحصول عليها من خلال صندوق الانتخابات.
علمانية شاملة وأخرى جزئية
ويرى عبد السلام قريمس، نائب رئيس حركة البناء الوطني أنه ينبغي هنا أن نميّز بين مصطلحين اثنين وهما مصطلح "العلمانية الشاملة" و"العلمانية الجزئية". فالعلمانية الشاملة هي خيار فكري مادي عبثي يهدف إلى إيجاد قطيعة بين القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية وبين حركة الحياة ومقتضياتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. أما العلمانية الجزئية فهي ليست خيارا فكريا بل خيار سياسي يهدف إلى فصل الدين عن إدارة الدولة والحياة السياسية. وهذا الفصل ليست له مبررات فكرية عند أصحاب هذا الخيار بل مبرراته كلها سياسية.

ويوضح نائب حركة البناء الوطني عبد السلام قريمس لـ "عربي21"، أن الجزائر بلد كبير وشعبها عريق في قبول الاختلاف الفكري وتنوعه، ولكنه في الوقت نفسه شعب أصيل مستمسك بقيمه وثوابته، ولا أعتقد أن يكون هناك من يؤمن بمفهوم العلمانية الشاملة في الجزائر كخيار فكري يحارب القيم والمقدسات، وإنما قد يوجد من يرى خيار إبعاد الدين عن الحياة السياسة وإدارة شؤون الدولة ولو بطرق غير ديمقراطية.
ويعتقد أن هناك رموزا وأسماء محسوبة على الاتجاه العلماني في الجزائر ولكن أغلبها لا يحبذ أن يوصف بهذا الوصف، للخصوصية الثوابتية التي يتمسك بها غالبية الشعب الجزائري، ولكن دورها محدود وليست لها مساهمة فكرية ولا سياسية معتبرة مثلها مثل الكثير من العلمانيين في وطننا العربي، وإنما أغلب اجتهادهم يتمثل في تقليد وتكرار نفس المقولات التي ينتجها العلمانيون في الغرب.
وعليه لا يعتقد الأستاذ عبد السلام قريمس أن يكون للعلمانية بشكل عام في الوطن العربي مستقبل ما دامت بعيدة عن الإبداع الفكري وما دامت مرتهنة لا تعيش إلا في أجواء الأنظمة الاستبدادية الفاسدة ومعزولة عن حاضنتها الشعبية والاجتماعية.
لا يمكن الفصل بين الفكري والسياسي
في المقابل يعتقد الدكتور ناصر جابي المختص في علم الاجتماع أن الفصل بين الفكري والسياسي غير ممكن عمليا، فكل سياسة وراءها فكر مهما كان وبالتالي فإن العلمانية هي موقف ورؤية فكرية في المقام الأول يمكن أن تعبر عن نفسها بالأدوات السياسية في المجال السياسي. وبالتالي فهو لا يرى أي انفصال بين المستويين.
ومع ذلك يستدرك الدكتور ناصر جابي أن الوضع في الجزائر ليس ناضجا تماما فالعلماني فكريا قد لا يجد الأدوات السياسية الحزبية على سبيل المثال التي يعبر من خلالها. فالسوق السياسية ومدى حريات التعبير كذلك لا تسمح بالنقاش المفتوح مما قد يمنع أصحاب الفكر العلماني من التعبير عن مواقفهم.
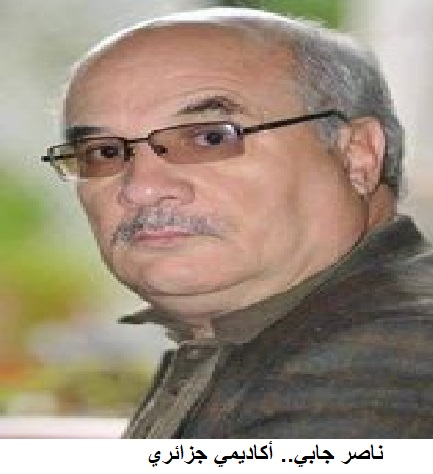
إن العلمانيين العرب في تحليل الدكتور جابي لـ "عربي21"، لا يسمح لهم دائما الوضع الثقافي والحريات بالتعبير عن آرائهم رغم دفعهم لثمن غالٍ عن آرائهم العلمانية التي لا يتم التفريق بينها وبين الإلحاد والموقف المعادي من الدين نظرا لما يميز الساحتين السياسية والثقافية في العالم العربي والجزائر. التي لا زال فيها مفهوم العلمانية غامضا ويتعرض للتشويش رغم أنها قد تكون الحال في الكثير من الحالات الوطنية لما تقدمه من حلول خاصة في الدول والمجتمعات المتنوعة دينيا وحتى في حالات الأحادية الدينية والمذهبية بعد علامات ظهور سوق دينية جديدة تتميز بإعادة النظر في مكانة الدين وظهور مواقف نقدية كثيرة عند الشباب.
خيار سياسي
من جانبه يعتقد الكاتب الجزائري المقيم بدبي محمد حسين طلبي أن العلمانية كمفهوم ظل يتوسع مع الزمن، فالعلمانية مفهوم فكري في الأساس راحت السياسة تتكئ عليه وتمنحه ما يتيسر ويستجد من التفسيرات والقناعات حتى لو فرضت بالقوة.
أما بالنسبة إلينا في الجزائر فإن ثورتنا الجبارة قد اعتمدت في مبادئها ومراحلها جميعا على إرث الحركة الوطنية التي انبثقت أصلا من جملة المقاومات ضد الاستعمار الاستيطاني الفرنسي لبلادنا بما فيها بطبيعة الحال الحركة الإصلاحية... والحركتان مصدرهما الموروث الشعبي الناصع للفكر العربي/ الإسلامي الذي يضم الموروث الأمازيغي الطيب.

ويضيف محمد حسين طلبي أن الجزائر بعيد الاستقلال المجيد تسير بذات الاتجاه تقريبا في ممارساتها السياسية بالتوازي مع الأفكار السائدة في المنطقة العربية التي كان لها جميل الأدوار في الوقوف إلى جانبنا إبان ثورة التحرير... وكان الخط البياني للتوجه الثقافي والسياسي قريبين من المبادئ الأصيلة إياها.. ثم راحت الأفكار والتطورات تمتدان نحو التوجه الاشتراكي المغري وقتها والحامل في طياته عروق الفكر العلماني المبسط والإنساني ولكن الصارم في صداميته والواعد في طموحاته بالرغم من فشله في تحقيق التنمية التي بالغ في الوعد بها.. ولأسباب عدة راح بدوره يفقد البريق شيئا فشيئا في مواجهة الغرب الصريح في علمانيته بكل معانيها والتي تستند كما أسلفنا إلى إرث واسع من الأفكار والحريات المغرية والجاذبة للمجتمعات في كل مكان بما فيها مجتمعاتنا المحافظة.
ويخلص محمد حسين طلبي في حديثه لـ "عربي21"، إلى ضرورة التكيف مع مبادئ يقال بأنها إنسانية بما في ذلك العلمانية.. إلا أن التمسك بخصوصيتنا العربية الإسلامية ضروري في مواجهة أي شذوذ أو اختراقات لها في هذا العالم الذي لا يتوقف عن التعولم على طريقته. وفي هذه الحالة نعتقد أن هذه العلمانية ستكون ربما خيارا سياسيا.
أوروبا تراجع نموذجها الحضاري
أما الدكتور جباب نور الدين، أستاذ الفلسفة بجامعة الجزائر فيعتبر أن العلمانية في سياقها التاريخي كانت حلا وحتمية تاريخية في إطار الصراع الذي عرفته أوروبا بين القوى الجديدة الصاعدة وهي الطبقة الرأسمالية والقوى التي وصلت إلى حدودها التاريخية، وهو الإقطاع المتحالف مع الكنيسة التي جعلت الدين أداة في خدمة الامتيازات ومصالح الإقطاع، فانتهى الصراع لصالح الطبقة الجديدة التي أسست الدولة العصرية التي ميزت بين المجال السياسي والمجال الديني حيث أصبح الدين شأنا خاصا.
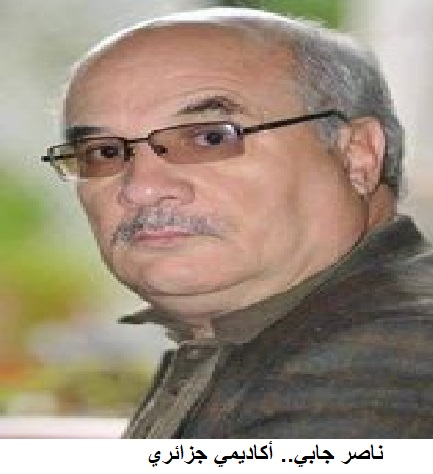
ويتساءل الدكتور جباب نور الدين هل أوروبا هي الطريق الوحيد والأوحد ولا طريق سواه الذي يجب أن نسلكه نحو التقدم، أم توجد طرق أخرى يمكن لنا أن نسلكها نحو التقدم وتجاوز التخلف دون المرور عن طريق أوروبا؟ قبل أن يجيب أن الكثير من المفكرين اليوم يتحدثون عن الأنماط الحضارية المتعددة، وأوروبا تمثل أحد هذه الأنماط الحضارية، وما يزيد من أهمية هذه التساؤلات ما تعرفه أوروبا في السنوات الأخيرة من مراجعات عميقة لتاريخها ومسارها الذي بلغ حد مراجعة الموقف السابق من القرون الوسطى وما كان يصطلح على تسميته بعصر الظلام وهي بداية للمصالحة مع الدين وهو ما يؤدي بالضرورة إلى مراجعة العلمانية التي تتعرض هي الأخرى للكثير من النقد من طرف كبار المفكرين مثل الفيلسوف "هابرماس" الذي يرى أن العلمانية انحرفت عن مسارها وتحولت من آلية سياسية للتنظيم لتصبح دعوة لإفراغ الكون من مضمونه الميتافيزيقي.
لكن ذلك برأي الدكتور جباب نور الدين يجب ألا يفهم منه أنها دعوة للتخلي عن العلمانية إنما هي دعوة لتصحيحها والعودة بها إلى مسارها الحقيقي.. هذه المراجعات الفكرية وهذا السجال الفكري، يعني فيما يعني أن أوروبا بصدد مراجعة نموذجها الحضاري.
التحليل الميكانيكي للعلمانية العربية
ويؤكد الدكتور جباب نور الدين في حديثه لـ "عربي 21"، أن الحديث عن رموز واتجاهات العلمانية في الجزائر، شائك ومتداخل ومعقد، يعود إلى الوضع الثقافي الخاص في الجزائر الذي ورثناه عن الاحتلال وكرسه الاستقلال، بخاصة الانقسامية اللغوية، إذا صح تسميتها كذلك، بين معرب ومفرنس التي تحولت إلى حرب حقيقية ولعبت دروا كبيرا في تشويه الوعي وتزييف النقاش حيث تصدرت الحياة الفكرية مفردات ومصطلحات عمقت الخلاف وشوهت النقاش من الطرفين، من ضمنها مصطلح العلمانية الذي تعرض لأكبر عملية انتهاك وتحريف وتحولت الدعوة العلمانية، بوصفها آلية سياسية من أجل تنظيم الحكم، إلى حرب لا هوادة فيها على الدين باسم الحداثة والتقدم والعصر، علما أن العلمانية لم تكن يوما حربا على الدين، وهو ما جعل الطرف الآخر يتصدى لهذه الدعوة باسم الدفاع عن ثوابت الأمة ومقوماتها، وهو ما جعلنا ندخل في نقاش زائف غير مجدٍ عقيم ومبتذل.
ويخلص الدكتور جباب نور الدين إلى القول: إن شيخ العلمانيين في العالم العربي صادق جلال العظم، كان أستاذي بجامعة دمشق وهو صاحب كتاب "نقد الفكر الديني" الذي نشره في الستينيات وأثار ضجة كبيرة وحوكم بسببه، لكن من يطلع على متن الكتاب لا يجد فيه جديدا إلا الهجوم على الدين بشكل مجرد وترديد مقولات ومفاهيم منزوعة من سياقها التاريخي وتوظيفها دون تأصيل، في واقع مغاير ومختلف، وهذا ينسحب على معظم العلمانيين في العالم العربي الذين ظلوا عاجزين وغير قادرين على إدراك الخصوصية الثقافية والتاريخية بخاصة فهم حقيقة الإسلام الذي يختلف عن المسيحية، ذلك كله جعل العلمانيين العرب يسقطون في المماثلة والتحليل الميكانيكي والتخطيط المجرد وأصبحوا يرددون مقولات منزوعة من سياقها التاريخي لم تضف جديدا لواقعنا.

